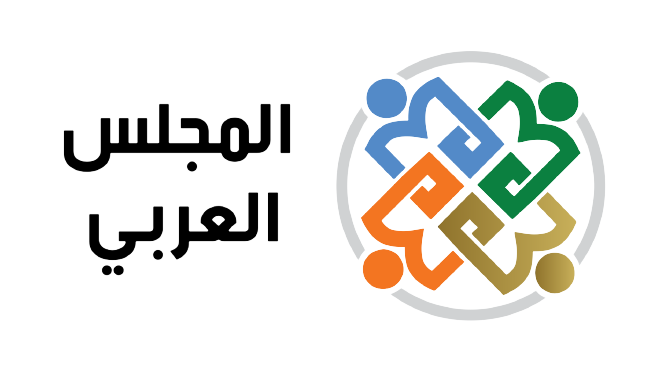مدخل :
في ظل الأوضاع المتأزمة التي يعيشها العالم العربي، حيث تتعثر مسارات التحول الديمقراطي وتتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية، برزت الحاجة إلى إطار نظري وعملي يحدد ملامح المشروع الديمقراطي العربي، ويوضح السبل الكفيلة بتحقيقه. جاءت وثيقة العهد الديمقراطي العربي استجابة لهذه الحاجة، إذ تطرح رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي ومستدام، لا يقتصر على تغيير الحكومات، بل يشمل بناء منظومة سياسية عادلة تعترف بحقوق الإنسان، وتحترم الحريات، وتضمن العدالة الاجتماعية.
ترتكز الوثيقة على جملة من المبادئ الأساسية التي تشكل قواسم مشتركة بين القوى الديمقراطية، وتؤكد أن الديمقراطية ليست مجرد نظام حكم، بل هي ثقافة وأسلوب حياة ينبغي ترسيخه في وعي الأفراد والمجتمعات. كما تسلط الضوء على المخاطر التي تهدد الديمقراطية، سواء من قبل الأنظمة الاستبدادية التي تسعى لإجهاضها، أو من خلال العوائق الداخلية التي تجعل عملية التحول بطيئة ومتعثرة. وبذلك، تضع الوثيقة خارطة طريق لبناء مجتمعات ديمقراطية، تعيش في ظل حكم القانون، وتتمتع شعوبها بالكرامة والحرية.
*النضال من أجل الحرية والكرامة*
تؤكد الوثيقة أن الحرية والكرامة ليستا هبات تُمنح للشعوب، بل حقوق تُنتزع بالنضال المستمر. فالتاريخ البشري عبارة عن سلسلة طويلة من المعارك من أجل التحرر، بدءًا من النضال ضد العبودية، مرورًا بالصراعات ضد الاستعمار، ووصولًا إلى معركة الشعوب ضد الاستبداد السياسي. في هذا السياق، فإن النضال من أجل الديمقراطية في العالم العربي يمثل الحلقة الأخيرة من هذا المسار، إذ لا يمكن الحديث عن كرامة إنسانية في ظل أنظمة قمعية تحتقر مواطنيها، وتحرمهم من أبسط حقوقهم.
إن الحرية ليست مجرد مفهوم نظري، بل هي شرط أساسي لنهضة الشعوب وتقدمها. فالدول التي نجحت في بناء أنظمة ديمقراطية مستقرة، مثل جنوب إفريقيا بعد انتهاء نظام الفصل العنصري، أو دول أوروبا الشرقية بعد سقوط الشيوعية، استطاعت أن تحقق تقدمًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملحوظًا. في المقابل، فإن الأنظمة الاستبدادية التي تكرس الحكم الفردي وتقمع الأصوات المعارضة تظل عاجزة عن تحقيق تنمية حقيقية، لأن التقدم يتطلب مجتمعات حرة قادرة على الإبداع والمساءلة والمشاركة في صنع القرار.
*رفض الاستبداد بكل أشكاله*
ترى الوثيقة أن الاستبداد ليس مجرد ممارسة سياسية، بل هو منظومة متكاملة تشمل أدوات القمع والتضليل والتزييف. فالأنظمة الاستبدادية لا تقتصر على استخدام العنف المباشر ضد المعارضين، بل تلجأ أيضًا إلى الإعلام المضلل، والتشريعات القمعية، والانتخابات المزورة، بهدف خلق حالة من الخضوع الجماعي تجعل المواطنين عاجزين عن مقاومة الظلم.
إن أخطر ما في الاستبداد أنه يخلق شعوبًا فاقدة للثقة في نفسها، ترى في القمع قدرًا لا مفر منه، وتتقبل انتهاك حقوقها دون مقاومة. ويظهر هذا بوضوح في المجتمعات التي تعاني من القهر السياسي لعقود طويلة، حيث تصبح الحرية فكرة غريبة، والديمقراطية مطلبًا ثانويًا أمام الحاجة إلى الأمن والاستقرار. هذا ما حدث في بعض الدول العربية بعد انتفاضات الربيع العربي، حيث تمكنت الأنظمة المستبدة من استغلال الفوضى لإقناع المواطنين بأن القمع هو الثمن الضروري للاستقرار.
لكن التجربة التاريخية تثبت أن الاستقرار القائم على الاستبداد هش وزائف، إذ سرعان ما ينهار عند أول اختبار حقيقي. فقد شهدنا كيف انهارت أنظمة ديكتاتورية بدت قوية ومتجذرة، مثل نظام زين العابدين بن علي في تونس، أو نظام حسني مبارك في مصر، بمجرد أن فقدت السيطرة المطلقة على المجتمع. وهذا يؤكد أن القمع لا يمكن أن يكون أساسًا لحكم مستدام، وأن الديمقراطية هي السبيل الوحيد لبناء مجتمعات مستقرة وقادرة على التطور.
*تحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب الحرية السياسية*
توضح الوثيقة أن الديمقراطية ليست مجرد تداول سلمي للسلطة، بل ينبغي أن تكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان توزيع عادل للثروة، وحماية حقوق الفئات المهمشة. فالتجربة أثبتت أن الديمقراطية التي تقتصر على الانتخابات دون معالجة الفجوة الاقتصادية والاجتماعية تفقد مشروعيتها سريعًا، لأنها لا تقدم حلولًا عملية لمشاكل المواطنين.
في هذا الإطار، تعتبر الوثيقة أن الديمقراطية الحقيقية هي التي تضمن لكل فرد حقه في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، وتكافؤ الفرص. وتؤكد أن الفساد الاقتصادي هو أحد أكبر العقبات أمام تحقيق التحول الديمقراطي، إذ غالبًا ما تستخدم النخب الحاكمة موارد الدولة لترسيخ سلطتها، وحرمان المعارضين من أي فرصة حقيقية للمنافسة.
تظهر أهمية الدمج بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في التجارب الناجحة حول العالم. ففي دول مثل السويد وكندا، لم تقتصر الديمقراطية على توفير الحريات السياسية، بل ضمنت أيضًا مستويات عالية من العدالة الاجتماعية، مما جعلها نموذجًا للاستقرار والتقدم. في المقابل، فإن الديمقراطيات الهشة التي لم تهتم بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية سرعان ما واجهت اضطرابات وانهيارات، كما حدث في العديد من دول أمريكا اللاتينية.
*رفض الاستعمار والاستبداد بوصفهما وجهين لعملة واحدة*
ترى الوثيقة أن الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي ليست مجرد ظاهرة محلية، بل هي جزء من منظومة عالمية تضمن استمرار الهيمنة الأجنبية على مقدرات الشعوب. فالعديد من الأنظمة القمعية في المنطقة ترتبط بعلاقات وثيقة مع قوى خارجية تحميها وتدعمها، مقابل استمرارها في تنفيذ سياسات تتماشى مع المصالح الدولية، وليس مع مصالح شعوبها.
لقد كان الاستبداد دائمًا أداة للاستعمار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ففي عهد الاحتلال الأوروبي للمنطقة، اعتمدت القوى الاستعمارية على أنظمة محلية قمعية لضمان السيطرة على الشعوب، وعندما انتهى الاحتلال الرسمي، استمرت هذه الأنظمة في أداء الدور نفسه، ولكن تحت مسميات وطنية. لذلك، فإن النضال ضد الاستبداد لا ينفصل عن النضال من أجل الاستقلال الحقيقي، القائم على سيادة الشعوب وليس على تبعية الأنظمة.
*مواجهة التطبيع والتخادم مع المشروع الصهيوني*
تعتبر الوثيقة أن التعاون مع الكيان الصهيوني يمثل أحد أخطر أشكال الاستبداد، لأنه يتناقض مع حقوق الشعوب العربية في تقرير مصيرها، ويدعم مشروعًا استيطانيًا قائمًا على الاحتلال والعنصرية. وترى أن أي نظام ديمقراطي حقيقي يجب أن يكون منحازًا إلى الحقوق الفلسطينية، لأن الديمقراطية تعني دعم الحرية لجميع الشعوب، وليس فقط داخل حدود الدولة.
لقد أثبتت التجربة أن الأنظمة التي تهرول نحو التطبيع ليست بالضرورة أنظمة قوية، بل هي غالبًا أنظمة مستبدة تبحث عن حماية خارجية لمواجهة شعوبها. ولذلك، فإن مواجهة المشروع الصهيوني لا تكون فقط بالمواقف السياسية، بل أيضًا ببناء أنظمة ديمقراطية قوية قادرة على تحقيق استقلالها الحقيقي، وفرض إرادة شعوبها في القضايا المصيرية.
*الشباب ودورهم في التحول الديمقراطي*
تشدد الوثيقة على أن الشباب هم الفاعل الأساسي في أي عملية تحول ديمقراطي حقيقي، فهم الفئة الأكثر تضررًا من الاستبداد والفساد، وفي الوقت ذاته القوة الأكثر ديناميكية وقدرة على إحداث التغيير. لقد كانت الحركات الشبابية في مقدمة الانتفاضات والثورات الديمقراطية التي شهدها العالم العربي، حيث لعبت دورًا محوريًا في كسر حاجز الخوف، وطرح مطالب الحرية والعدالة بجرأة غير مسبوقة.
لكن رغم هذا الدور الحيوي، فإن الشباب يواجهون العديد من العقبات التي تعرقل مشاركتهم الفعالة في العمل السياسي والمجتمعي. فالقمع الأمني، وغياب الفرص الاقتصادية، واحتكار النخب التقليدية للمجال السياسي، كلها عوامل تدفع الكثير من الشباب إما إلى العزوف عن السياسة، أو إلى البحث عن بدائل غير ديمقراطية للتغيير. لذلك، تؤكد الوثيقة على ضرورة دعم الحركات الشبابية، وإيجاد مساحات حقيقية تمكنهم من المشاركة في الحياة العامة، سواء من خلال الأحزاب السياسية، أو منظمات المجتمع المدني، أو عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية التي أصبحت منبرًا هامًا للتعبير والتأثير.
لا يمكن تحقيق تحول ديمقراطي مستدام دون أن يكون الشباب في صلبه، ليس فقط كأدوات للتغيير، بل أيضًا كقادة للمستقبل. إن بناء جيل جديد يؤمن بالديمقراطية كقيمة وممارسة، ويعمل على ترسيخها في المجتمع، هو الضمانة الحقيقية لعدم عودة الاستبداد مرة أخرى. ومن هنا، فإن الوثيقة تدعو إلى الاستثمار في تعليم الشباب، وتدريبهم على المهارات القيادية، وتعزيز وعيهم السياسي، حتى يكونوا قادرين على قيادة عملية الانتقال الديمقراطي، ليس فقط كشعارات، بل كواقع ملموس.
*آليات التفعيل والعمل لتحقيق الديمقراطية*
حتى لا تبقى المبادئ الواردة في الوثيقة مجرد طموحات نظرية، من الضروري تبني آليات واضحة وفعالة لتحقيق التحول الديمقراطي على أرض الواقع. تؤكد الوثيقة أن أولى خطوات التفعيل تتمثل في بناء مؤسسات ديمقراطية قوية، تعتمد على الفصل الحقيقي بين السلطات، واستقلال القضاء، وضمان نزاهة الانتخابات. فبدون مؤسسات قادرة على حماية الديمقراطية، ستبقى العملية الديمقراطية معرضة للانتكاسات في أي لحظة.
ترسيخ ثقافة الديمقراطية في المجتمع هو أيضًا جزء أساسي من عملية التفعيل، حيث يجب أن تصبح الديمقراطية جزءًا من المناهج التعليمية، والخطاب الإعلامي، والأنشطة الثقافية، بحيث لا تقتصر على المجال السياسي فقط، بل تمتد إلى كل مجالات الحياة. فالديمقراطية لا تعني فقط وجود انتخابات، بل هي طريقة تفكير تقوم على احترام التعددية، وقبول الاختلاف، وإدارة الخلافات بطرق سلمية وحضارية.
المجتمع المدني يمثل كذلك ركيزة هامة في تفعيل الديمقراطية، إذ يمكنه أن يلعب دورًا رقابيًا على أداء الحكومات، ويكون منصة للتوعية والتدريب والمناصرة. لذلك، تشدد الوثيقة على أهمية دعم المنظمات الحقوقية، والنقابات العمالية، والحركات الشبابية، وكل الفاعلين الذين يسعون إلى بناء مجتمع أكثر عدالة وانفتاحًا.
لا يمكن إغفال أهمية التعاون بين القوى الديمقراطية العربية، لأن التحديات التي تواجه الديمقراطية ليست محلية فقط، بل هي جزء من صراع إقليمي ودولي، حيث تعمل الأنظمة المستبدة على تبادل الخبرات والأساليب لقمع شعوبها، مما يستدعي بدوره تنسيقًا بين القوى الساعية للتحرر والديمقراطية. فكما أن هناك “غرفة عمليات” موحدة لإفشال الديمقراطية في المنطقة، يجب أن يكون هناك أيضًا “تحالف ديمقراطي” يعمل على مواجهة هذه التحديات، وتبادل الخبرات، وتقديم الدعم المتبادل بين القوى الديمقراطية في مختلف الدول العربية.
*خاتمة: نحو مستقبل ديمقراطي حقيقي*
إن الرهان على الديمقراطية هو رهان على المستقبل، والمستقبل لا يُصنع إلا بإرادة الشعوب، وإصرارها على انتزاع حقوقها، مهما كانت التحديات.
ندرك أن التحول الديمقراطي في العالم العربي لن يكون سهلًا، لكنه ليس مستحيلًا. فالتاريخ أثبت أن الشعوب قادرة على إسقاط الأنظمة القمعية، وبناء أنظمة جديدة تحقق طموحاتها في الحرية والكرامة. لكن هذا يتطلب وعيًا عميقًا بضرورة تجاوز الانقسامات الداخلية، وتوحيد الجهود لبناء مشروع ديمقراطي متكامل، لا يقتصر على تغيير الحكومات، بل يهدف إلى بناء مجتمعات حرة ومستقلة وقادرة على تقرير مصيرها.
توفيق الحميدي | محامي وناشط حقوقي يمني